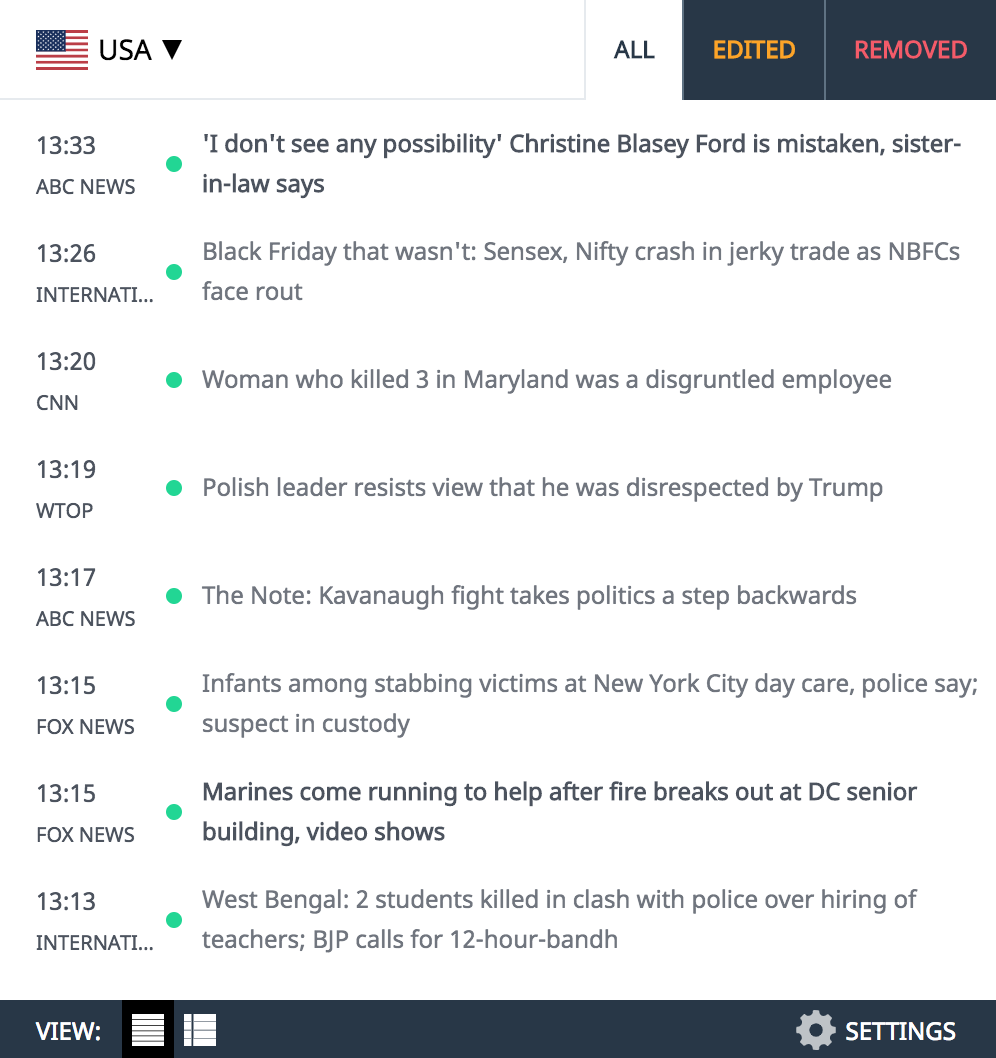تناقضات يعيشها المجتمع المغربي اليوم، تجد جذورها في مرحلة الصدمة الاستعمارية، خاصة في النصف الأول من القرن العشرين، وما تلته من هزات “غيرت كل شيء” في المغرب.
في متم القرن العشرين، وبداية قرننا الحادي والعشرين الراهن، رصد المؤرخ إبراهيم بوطالب، الذي رحل عن دنيا الناس سنة 2022، “معالم التغيير في تاريخ المغرب في القرن العشرين”، في منشور صادر عن كلية الآداب بجامعة ابن زهر بأكادير، يحمل رصدا لمعالم التغير الذي طال البلاد وساكنتها، ويقدم عناصر تفسير معتبرة.
وكتب بوطالب أنه بعدما “فرضت الحماية الأجنبية علينا فرضا، بسبب تحفظنا من (الإصلاح)”، عَلمَ “الكفاح الوطني” المغاربة “معنى الثورة وكيف نثور”؛ وهكذا “تخلصنا من الحماية الأجنبية سنة 1956، بسبب وقوفها عرقلة في طريق ما غدونا نتشوف إليه من الثورة”.
لكن، أضاف إبراهيم بوطالب: “لئن كان من فضائل الجمود أنه يصون الانسجام مع النفس، فمن مساوئ الثورة أنها تؤجج أسباب الانفصام. ولقد كنا، في مطلع القرن، على ثقافة واحدة وعلى لغة كتابية واحدة. أما في منتصف القرن، فقد صرنا أمام ثقافتين، وأمام لغتين، بل ثلاث لغات للتواصل الكتابي”.
وتابع المؤرخ المغربي الراحل: “اللغة منطق. وكان لزاما علينا أن نتعلم منطق الخصم لنحتج عليه بنفس ما كان يحتج به علينا. على أنه لا يلزم من استعمال لغة الخصم لضرورة الكفاح، التسليم باللغة الوطنية التي هي متنفسنا على مر العصور (…) إلا أن يكون ذلك من تبعات من يقع متأرجحا بين المحافظة وبين التغيير، وبين الأصالة والحداثة، وبين الثورة والتقليد. وقد دخلنا تلك المرحلة بعد الاستقلال سنة 1956 ونحن نتوهم أننا اخترنا نهائيا طريق الثورة. ولكن الإجماع يومئذ سرعان ما اصطدم بما كان قد تغير فينا وربما لم يكن قد دخله التغيير بعد”.
واسترسل بوطالب شارحا: “الثقافة هي روح الأمة بالضبط. وروح الأمة هي لغتها. ويبدو لي أننا فقدنا في هذا النصف الثاني من القرن العشرين ما كنا عليه أيام الكفاح ضد الاستعمار من الإجماع على أن اللغة العربية هي سبيل النهضة الثقافية والتحرر من الأمية ودعم صفوف الأمة… الذي نحن عليه اليوم هو العكس، فنحن في حالة من الانفصام الثقافي. حيث يلغو كل واحد منا بلغوه، ولا يريد أن يصغي لما يقوله الآخر. وقد يقال إنها حالة قديمة فينا متأصلة. ولكنني أقول إن الهوة الثقافية لم تكن لتؤثر فينا يوم كانت السوق المغربية أسواقا منعزلة متعددة لا تتجاوز علاقاتها جوارها القريب. أما وقد أصبحت السوق المغربية سوقا وطنية متماسكة، يرتبط الفرع منها بالأصل، فلا بد من لغة واحدة لدعمها ومن أداة واحدة لرواج منتجاتها في الداخل وفي الخارج”.
هذا “الافتقار إلى وحدة اللغة”، كان من نتائجه بالنسبة للمؤرخ “تعثر في تعميم التعليم”.
وفسر بوطالب الاحتلال الأجنبي بقوله: “لما باتت الدولة في تناقض عنيف مع مجتمعها، تسرب الاستعمار من ذلك المسرب؛ ففرض عليهما أسباب التغيير قبل أن تكون الأمة قد غيرت ما بنفسها”، وبما أن “الإنسان لا يتغير، فردا كان أو جماعة، إلا من خلال الأزمات والهزات العنيفة”؛ فقد “فتحت الحماية أبواب التغيير أمامنا، وأقحمتنا فيه مرغمين أول الأمر. حتى إذا ركبنا تلك المطية وصرنا نركضها ركضا، انزعجت الأوساط الاستعمارية من ذلك خوفا على مصالحها. فكان لا بد أن نتخلص من الحماية بعد أن تحولت إلى عرقلة لتعميم التغيير في البلاد والعباد”.
لكن ذلك لم يحدث حتى “أطاحت بما أطاحت به مما كان ينبغي أو لا ينبغي أن يطاح به. وأقامت مقامه ما كان مرغوبا في إقامته أو غير مرغوب في إقامته على الإطلاق. وقلبت الحماية البلاد رأسا على عقب، محتفظة بما بدا لها مفيدا أو ضروريا أن تحتفظ به، ومجبرة سكان البلاد على دخول العصر طوعا أو كرها، ممكنة إياهم في ذات الوقت من وسائل التخلص منها”.
ورسم بوطالب معالم المشهد المغربي عند مطلع القرن العشرين، قائلا إن المغرب كان يبدو “على شكل مجموعة من القبائل؛ منها الأمازيغي، ومنها العربي، ومنها السوداني، ومعظمها خليط من كل ذلك بما ظل يجري بينها من الصراع على الماء والكلأ عبر السنين والعصور”، وكانت “لا تعرف معنى للحدود. فلا تقف إلا عند الاصطدام بمجال القبائل المجاورة. ولم تنظر للفرنسيين بعد احتلالهم الجزائر وبداية تسربهم في واحات شنكيط، إلا على أنهم دخلاء أعداء الدين الذين جاؤوا يزاحمونها في تراب الأجداد. فكانت في قتال مستمر معهم، ذلك أن القبيلة تشكيلة جندية فهي مسلحة لزوما”.
وواصل: “الإنسان المغربي يومئذ لا يُتَصَور إلا حاملا للسلاح، ورزقه حتما على رمحه. ولذلك، كان الاقتتال هو الحالة الطبيعية. وكان السلم هو الاستثناء”، في وقت كانت فيه “البادية هي صاحبة الحل والعقد في البلاد. ولا وزن بالنظر إليها للحواضر مهما كان من صيتها”.
وتوقف بوطالب عند هيمنة الثقافة الشفوية في مغرب ما قبل الاستعمار التي “من الواضح أنها كانت مسايرة لهيمنة الاقتصاد الرعوي والترحال”، والاقتصار في ترويج الكتب على الاستنساخ، “ويوم دخلت المطبعة الحجرية البلادَ سنة 1864 فإنها لم تتجاوز دائرة محدودة من رجال العلم في مدينة فاس. كما لم تتجاوز دائرة العلوم الدينية التي عليها المدار منذ عهد ابن خلدون”، وهو ما كان معه “وقف العلم والتعليم عليها ليس عائقا لتطور المعرفة وتنقيح العقول وحسب، وإنما كان أيضا عنوان التقوقع والتستر على الجهل باسم المقدسات”.
وزاد: “الثقافة شأنها شأن الاقتصاد. فإنها كانت مبنية على القلة، يحتل فيها حفظ المتون الدينية كل المجال مثلما تحتل تربية الماشية وزراعة الحبوب كل المجال الفلاحي، والنسيج والحدادة والنجارة كل المجال الصناعي. فلا وجود يومئذ لعلوم الطب ولا لعلوم الطبيعة ولا للرياضيات، ولا لعلوم الاجتماع مثل التاريخ والجغرافية، فأحرى أن تدرس الفلسفة التي حكم عليها بالإعدام منذ عهد الموحدين”.
لكن بعد خلخلة الاستعمار، حلت المدرسة محل “المسيد” وحلت جامعة محمد الخامس محل “القرويين”، و”لم يبق العلم وقفا على حاجيات الدين. ولكنه انفتح من جديد على ضرورات هذه الحياة الدنيا”.
و”كما أن العلم كان لا يتنفس إلا من جهة المقدس”، فكذلك “كانت روح الحكم مجسدة كلها في شخص السلطان. فهو أمير المؤمنين والإمام الذي تقام بوجوده الشرائع. ولولاه لأكل الناس بعضهم بعضا. ولعمت الفوضى. ذلك أنه هو المسؤول الأول عن المخزن. والمخزن، كما يدل على ذلك الاسم، هو بيت مال الجماعة المكلف طبعا وشرعا بخزن فائض الأيام السمان”.
في ذلك العهد، كانت مهام الدولة حفظ الجماعة من أن يتأذى بعضها ببعض بإقامة العدل بين الناس، والذود عن الحمى والتصدي لمن يريد بالأمة شرا، وجمع الأموال من صدقات المؤمنين وغيرها من الموارد، مثل الجمارك، للإنفاق على الجيش وإسعاف المحتاجين، وكانت “أداة الحكم الكبرى هي الحرْكة التي كان السلطان يتفقد من خلالها أحوال الأقاليم، كما كانت الرعية تطمئن بوجود العاهل وكانت الشهور والأعوام تنطوي قبل أن تحل نوبة إقليم معين في زيارة السلطان”.
وفيما عدا ذلك “لا دخل للدولة في شؤون الرعية. ولكل إقليم أن يتصرف بما يراه مناسبا لأحواله”، و”كانت البلاد مقسمة إلى أقاليم تنالها الأحكام السلطانية، وأخرى لا تنالها تلك الأحكام لتعذر وصول المخزن إليها بانتظام”.
أما مجتمعيا، فأول ما يسترعي الانتباه بعد الاستقلال، وفق الكاتب؛ “ارتفاع عدد المغاربة من أربعة ملايين نسمة إلى أزيد من ثمانية ملايين”، في وقت وجدت فيه الدولة المغربية نفسها “محررة من كابوس القبائل، محتكِرة لقوة السلاح بدون منازع داخل التراب الوطني”، بعدما نجحت “الجيوش الاستعمارية” في “تجريد القبائل من سلاحها بعد أزيد من عشرين سنة من المطاردة”؛ وهو ما ترتب عنه “رسو نهائي لخريطة القبائل؛ ورسو القبائل كناية عن الاستقرار”.
ثم صار “عدد القاطنين في المدن أكثر من عدد القاطنين في البوادي”، وأضحت “البادية اليوم هي التي توجد تحت ذمة المدن خلافا لما كنا عليه في مطلع القرن”، كما تحول المجتمع من هيمنة “الكهول من الذكور” إلى مجتمع يهيمن عليه جمهور الشباب من الذكور والإناث”، ثم “لما باتت القبيلة في خبر كان، حلت محلها الأسرة الأحادية النواة القائمة على الأبوين وأطفالهما”، وهي الأسرة – المصنع “الذي يصنع فيه المواطن المعروف بوظيفته في المجتمع أكثر مما هو معروف بحسبه ونسبه”.
وعلى الرغم من “تضخم المجتمع المغربي سنة 1956” فإنه “كان أقل تباينا واختلافا وأكثر تماسكا وانسجاما”، حسَبَ إبراهيم بوطالب الذي يعلق على هذه الملاحظة بقوله: “لعل مرد ذلك إلى ما كان الشعب عليه من نشوة الاستقلال، ومن عودة البلاد إلى وحدة التراب بعد أن محيت الحدود المصطنعة بين مناطق نفوذ الاستعمار الفرنسي والإسباني. فلا منطقة سلطانية ولا أخرى خليفية. ولا جيب في سيدي إفني ولا آخر في طرفاية. ولم يعد يميز بين المغاربة إلا ما ظهر من مميزات الأندية الرياضية الجديدة (…) التي انبعثت تلبية لحاجيات رياضية جديدة، ولكنها جاءت أيضا لتكرس تلك الحاجة إلى الاختلاف بعد أن تجاوزت الأمور القبلية والزاوية”.
ومع هذه التحولات “يجد المجتمع نفسه يعاني من أسباب التنافر الجديدة قبل أن تندثر فيه أسباب التنافر التقليدية. أو يعجز عن الصمود لأسباب الاختلاف الجديدة جراء ما تآكل من أسباب الائتلاف التقليدية، فيكون معرضا لكل الأخطار، متحيرا في التمسك بكل أسباب النجاة”.
وعلى الرغم من تقلص خريطة البلاد، فإن الاستقلال رافقه “تعمق سلطة الدولة في كل ناحية بشكل لا نظير له في التاريخ؛ فلم يبق شبر واحد من التراب الوطني يغيب ما يجري فيه عن أنظار المخزن المركزي، أو يقع فيه ما يخرج عن أوامره ونواهيه”، فاتضح “ما كان مبهما من طبيعة الدولة”، وورثت هذه الأخيرة “الإدارة الاستعمارية بكل ما أدخلته من المناهج العصرية، ومن روح المركزية”، وحل لفظ “الميزانية” في “دولة الإدارة” مقام “الحرْكة” في “دولة الإمامة”.
و”إذا كان المغرب مغارب في القديم، وكان الأوروبيون يسمونه بمملكة فاس ومكناس ومراكش وتارودانت” فإنه، غداة الاستقلال “أرض موحدة الأطراف، كاملة السيادة، يشد صفوف أبنائها بعضهم إلى بعض ما لم يسبق له نظير من مشاعر الأخوة في الدين والوطن. ولكنه منقسم في الواقع إلى بلدين، مثلما أن الفلاحة كانت فلاحتين، والصناعة صناعتين، والتجارة تجارتين. ولا يربط بينهما إلا وعي مبهم بحتمية الانتقال من الاقتصاد العتيق الرامي إلى التوفير والتقشف، إلى الاقتصاد الجديد الذي يهدف إلى تكديس السوق بالبضاعة والحث على الاستهلاك”.
وسجل المؤرخ المغربي الراحل “المفارقة” الكامنة في أن “النشاط الاقتصادي ما زال تحت رحمة الإنتاج الفلاحي؛ فإذا كان الموسم جيدا وسقطت الأمطار في إبانها، كان الرواج وصلحت أحوال الجميع. وإذا كان العكس ولم يجد الفلاح ما يروي به السوق، فإن الأزمة على الأبواب، وكأن شيئا لم يتغير بالرغم من كل ما حصل من الرقي. لكن علامة التغيير الكبرى وآية التقدم أن انهيار المحصول الزراعي من سنة إلى أخرى لم يعد يفضي إلى المجاعة والكوارث البشرية التي كانت تأتي على الأخضر واليابس”.
وفي مقارنة بداية القرن ونهايته، رصد إبراهيم بوطالب التحول الذي طال أهم مجالات عيش المغاربة: “ثقافتنا في نهاية هذا القرن ثقافتان، مثلما أن مجتمعنا مجتمعان، واقتصادنا نوعان من الاقتصاد يعطي كل واحد منهما بظهره للآخر”.
من بين هذه المجالات الاقتصاد، الذي سجل المؤرخ أن مغربَه في مطلع القرن الحادي والعشرين مغربان؛ “مغرب أدوات العمل والإنتاج على ما كانت عليه في طليعة القرن، المختفي في دكاكين الصناع التقليديين وفي طرازاتهم التي ما زالت تعمل بالمغزل والمنوال العتيق، وفي خبايا البوادي وثنايا الجبال التي ما زالت تعتمد المحراث الخشبي التقليدي والدورات الفلاحية المعهودة عند السلف. ومغرب المدن الزاهية والطرق الكبرى وخطوط السكك الحديدية والطائرات المحلقة”.